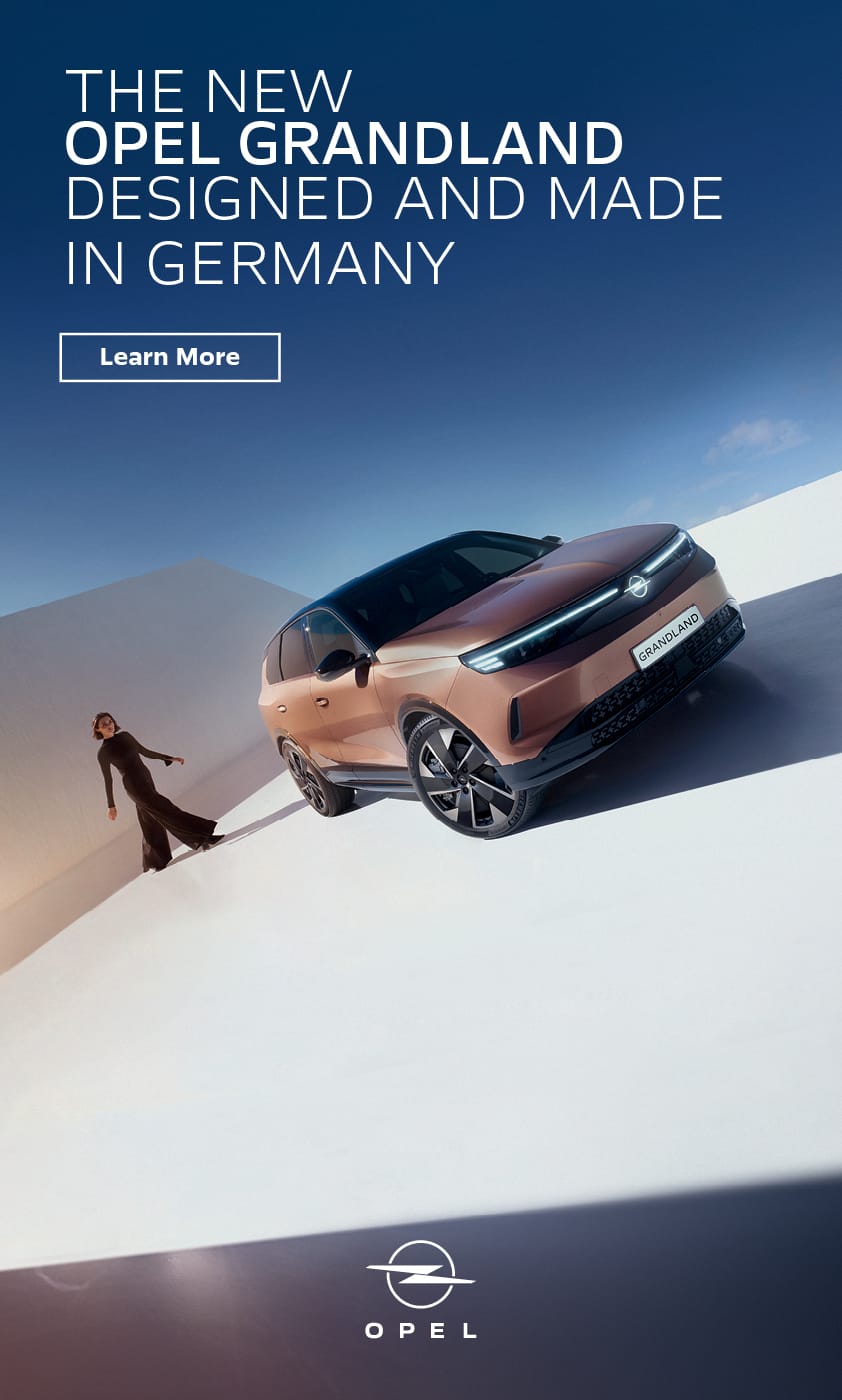المستشار محمد سليم يكتب : عزرائيل يسكن البيوت

لم يعد خبر قتل طفل على يد أبيه أو أمه صادمًا كما كان، وتلك هي الفاجعة الحقيقية. أن يمر الدم أمام أعيننا فنعتاده، وأن تتحول الجريمة من رجفة ضمير إلى سطر عابر في نشرات الأخبار، فهذا يعني أن الخلل لم يعد فرديًا ولا طارئًا، بل أصبح عطبًا عميقًا في بنية المجتمع ذاته.
حين يقتل الأب ابنه أو تُنهي الأم حياة طفلتها، فنحن لا نواجه مجرمًا فقط، بل نواجه انهيار فكرة كانت مقدسة في وعينا الجمعي: فكرة الأسرة. الأسرة التي كانت ملاذ الأمان تحولت في بعض البيوت إلى مصدر الخطر، وتلك ليست أزمة قانون ولا طب نفسي فقط، بل أزمة قيم في المقام الأول.
هنا يفرض السؤال نفسه بلا مجاملة: أين ذهبت القيم الدينية والأخلاقية التي تربت عليها أجيال كاملة؟ أين اختفى معنى الرحمة التي جعلها الدين أساس العلاقة بين الآباء والأبناء؟ كيف انقلب التكليف الإلهي بالرعاية إلى جريمة مكتملة الأركان؟
كان الأب يومًا رمز الحماية، وكانت الأم كما قال حافظ إبراهيم، «الأم مدرسة إذا أعددتها… أعددت شعبًا طيب الأعراق»
فماذا يحدث حين تسقط المدرسة؟ حين يتحول المعلم إلى جلاد، والمأوى إلى ساحة إعدام، والرحم إلى أداة قتل؟
إن قتل الأبناء ليس انفجارًا لحظة غضب، ولا نتيجة مباشرة للفقر أو الضغوط المعيشية كما يحلو للبعض أن يختصر القضية. الفقر عاشته أجيال سابقة، لكنها لم تذبح أبناءها. الضغوط مرت على مجتمعات أفقر وأقسى، لكنها لم تُنتج هذا الكم من الوحشية داخل البيوت. ما نراه اليوم هو نتاج غياب طويل للوعي، وتراجع حاد في الثقافة، وتآكل مستمر في منظومة القيم الدينية والاجتماعية.
لقد تخلّت الأسرة عن دورها التربوي شيئًا فشيئًا، وسلمت أبناءها لشاشات بلا ضمير، وخطاب إعلامي يطبع العنف، وفن يبرر الجريمة، ومحتوى رقمي يصنع القسوة دون أن يشعر أحد. ومع التكرار، تبلدت المشاعر، وأصبح الدم مشهدًا مألوفًا، وفقد الطفل قدسيته ككائن ضعيف يستحق الحماية المطلقة.
والأخطر أن الجريمة لم تعد تُقابل بدهشة كافية، بل بتبريرات جاهزة: اضطراب نفسي، خلافات أسرية، ضيق ذات يد. وكلها تفسيرات قد تشرح لكنها لا تبرر، وقد تُفسر الفعل لكنها لا تبرئ المجتمع الذي سمح بانحداره إلى هذا الدرك.
المجتمع الذي يفقد ثقافته يفقد بوصلته، وحين تغيب الثقافة الدينية الصحيحة، لا المتطرفة ولا الشكلية، يتحول الإنسان إلى كائن بلا رادع داخلي. وحين تنهار الثقافة الاجتماعية التي كانت تضبط السلوك، يصبح القانون وحده عاجزًا عن حماية الأرواح داخل البيوت المغلقة.
إن مواجهة هذه الكارثة لا تكون بالتحسر ولا بالخطابات الموسمية، بل بمشروع إنقاذ حقيقي يبدأ من الجذور. يبدأ بإعادة الاعتبار لدور الأسرة كمنظومة تربية لا كمجرد وحدة سكنية. ويبدأ بتأهيل نفسي وثقافي حقيقي للمقبلين على الزواج، لا على سبيل الرفاهية بل كضرورة أمن قومي.
كما يتطلب الأمر مراجعة جادة لدور الإعلام والفن، فالعنف الذي يُعرض بلا مسؤولية يتحول تدريجيًا إلى سلوك مقبول، والجريمة التي تُقدَّم في ثوب بطولة تخلق نماذج مشوهة في الوعي الجمعي.
ولا يمكن إغفال دور المؤسسات الدينية والتعليمية، التي يجب أن تعود للقيام بوظيفتها الأصيلة في بناء الإنسان لا الاكتفاء بالشكل والطقوس. فالدين الذي لا يُثمر رحمة هو دين غائب، والتعليم الذي لا يزرع القيم هو تعليم ناقص.
إن جريمة قتل الأبناء على يد آبائهم تعيد إلى الأذهان واحدة من أبشع جرائم الجاهلية: وأد البنات، لكنها اليوم أكثر قسوة، لأنها تُرتكب باسم الحداثة، وتحت سقف البيت، وعلى مرأى من مجتمع صامت. نحن أمام وأد جديد، لا يُدفن في الرمال، بل يُغرق في الأنهار ويُعلّق على المشانق داخل البيوت.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه بجرأة ليس: لماذا قتل هذا الأب طفله؟ بل: كيف سمحنا أن يتكوّن هذا الأب؟ وأين كنا حين انهارت القيم وسقطت الأم من مقام المدرسة، وتخلّى الأب عن معنى الأبوة؟
إن دم الأطفال ليس شأنًا فرديًا، بل جرس إنذار لمجتمع بأكمله. وإذا لم نتحرك الآن، فإن القادم سيكون أخطر، ولن يكون السؤال وقتها عن الجريمة، بل عن مصير أمة فقدت بوصلتها الأخلاقية.
رحمكِ الله يا أمي
تربّينا على يديك قبل أن نعرف معنى التربية، وتعلّمنا منكِ قبل أن ندخل المدارس، كبرنا ونحن نحمل في أرواحنا بصمتكِ التي لا تزول، علّمتِنا أن الرحمة ليست ضعفًا، وأن الحنان ليس ترفًا، وأن القيم لا تُقال بل تُعاش. كنتِ المدرسة الأولى، لا بالكتب ولا بالمناهج، بل بالفعل والقدوة والصبر الطويل.
علّمتِنا أن الإنسان يُقاس بأخلاقه لا بما يملك، وأن البيت الذي يخلو من الرحمة يتحول إلى جدران صمّاء مهما اتسع، غرستِ فينا معنى الأمان، فكبرنا نعرف أن الأبناء أمانة، وأن اليد التي تحتضن لا يمكن أن تؤذي، وأن الدعاء الصادق أقوى من ألف خطبة.
حين نرى اليوم ما يحدث من قسوة لم نعرفها، ندرك قيمة ما زرعتهِ فينا أكثر، ونعرف أن التربية الحقيقية تصنع إنسانًا لا مجرّد فرد. رحمكِ الله يا أمي، فقد كنتِ وطنًا صغيرًا نحتمي به، وضميرًا حيًا يذكّرنا كلما ضعُفنا أن الرحمة أصل، وأن القيم لا تموت ما دام هناك من تربّى عليها.
نمضي في هذا الزمن المضطرب ونحن نستحضر صورتكِ، لنقول إن ما أنقذنا هو أمٌّ عرفت رسالتها، وأن ما نحتاجه اليوم هو أن تعود الأمهات مدارس، لا مشانق
كاتب المقال المستشار محمد سليم عضو المحكمة العربية لفض المنازعات وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق والمحامى بالنقض